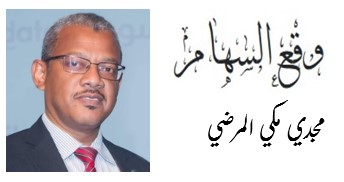نتباهى كثيراً -نحن السودانيين -بأننا خيرُ أُمةٍ أُخرجت للناس وأن الجينات التي نحملها لا مثيل لها عند باقي الشعوب وأن عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا ماركة مسجلة في الصحف الأولى باسم شعب السودان المختار، وما زلنا نسير بين الركبان ولسان حالنا يقول (انحنا الساس وانحنا الراس)، (وتصور كيف يكون الحال، لو ما كنت سوداني). ويسيطر علينا هذا الشعور منذ الصغر وينمو معنا ويكبر حتى يذهب بنا بعيداً إلى نهاياتٍ موغلة في المناطقية والجهوية والقبلية!
قد لا يتفق معي كثيرون في هذه المقدمة الصادمة، ولكن ربما تشاطرني الأقلية ذات الرأي. ولهذا فليكن ديدننا أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، وأن مساحات الحرية لا يجب أن تنمو فيها جذور العصبية، وأن ما تراه أنت حقيقة، أراه أنا سراباً، وأن ما أراه صائباً مفيداً، تراه أنت هباءً منثوراً!
ما دفعني إلى التفكير في هذا الأمر هو الحال الذي نحن عليه الآن، بعد اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023م، والتي تشكل علامة فارقة في حياة السودانيين وستظل ذكرى أليمة محفورة في دواخل الشعب السوداني إلى الأبد وجرحاً عميقاً غائراً في القلوب والنفوس يصعب علاجه مهما طال الزمن، وسيبقى أثرها جيلاً بعد جيل، لتبقى تاريخاً تدرسه الأجيال القادمة في منهجها الدراسي.
يتطلب الأمر العودة بالتاريخ إلى الوراء، ولتكن البداية من فجر الاستقلال المجيد، حيث نال السودان استقلاله في العام 1956م بعد تضحيات جسام من أبنائه، ولكن بعد عامين من الحرية الوطنية، انتقلت البلاد إلى حكم عسكري بعدما فشلت النخبة في إدارة البلاد، فبدأت المعارضة ورُفعت الشعارات المناهضة لحكم الفريق عبود حتى أطاحت به ثورة الشعب في أكتوبر 1964م.
فرح الشعب بأكتوبر الأخضر وغنى له الجميع، وأقمنا بعدها حكماً ديمقراطياً مارست فيه أحزابنا السياسية المراهقة تجاربها المختلفة علينا، وبينما كانت لا تزال سكرى بنشوة نصر أكتوبر حتى داهمها فجر الخامس والعشرين من مايو 1969م فألجم فرحتها وقمع نشوتها، وبقي نظام مايو جاثماً على صدر الوطن حتى انتفاضة أبريل 1985م التي أطاحت بطغمة مايو غير مأسوف عليها ليخرج الشعب بعدها منادياً بالقصاص ومردداً “راس نميري مطلب شعبي” ولكن النميري، رحمه الله، عاد من منفاه في القاهرة عبر مطار الخرطوم لتستقبله ذات الجماهير التي طالبت برحيله، وبقي مواطناً عادياً في بلدٍ كان يحكمه ستة عشرة عاماً حتى لقي ربه ووري تراب هذا الوطن الغالي.
جلس على كرسي الحكم بعد انتفاضة أبريل، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، رحمه الله، ذلك العسكري الزاهد صاحب المدرسة المتفردة في الوفاء بالعهود العسكرية، فسلم البلاد بعد عام واحد فقط من انتفاضة الشعب، أي في العام 1986م، إلى ذات الأحزاب القديمة التي جاءت إلى الحكم بعد ثورة أكتوبر 1964م، لتعود مرة أخرى، بكل جيناتها الفاشلة وصفاتها الوراثية الخائبة، لتمارس في هذا الشعب المسكين، شتى صنوف العربدة السياسية، فكانت المصالح الشخصية والمنافع الذاتية والموبقات الحزبية هي البرامج السياسية لهذه الأحزاب، وكان الوطن الجريح يتآكل والمدن السودانية تتساقط واحدة تلو الأخرى والدولة مشغولة بصياغة قرارات تعويضات آل المهدي!
لم تكد تمضي ثلاث سنوات عجاف على هذا العبث الحزبي، حتى أطل برأسه، من بين ركام تلك الفوضى، ثعبان الإنقاذ الأقرع، في الثلاثين من يونيو 1989م، فإذا هو يلقف ما يأفكون، لتبدأ أطول فترة حكم في تاريخ البلاد بعد الاستقلال، ولتعلن الإنقاذ عن مشروعٍ حضاري، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب!
كان بيان الإنقاذ الأول يتحدث عن التدهور المريع الذي تعيشه البلاد في كافة مناحي الحياة وانتقد الفشل الذي لازم المؤسسات الدستورية وندد بإضاعة الوحدة الوطنية وإثارة العنصرية والقبلية وسوء الأحوال الاقتصادية وتفشي الفساد ونمو الطبقات الطفيلية. وقد مرت ثلاثون سنة من عمر الإنقاذ، وبيانها الأول يصلح لأن يصف الحال السوداني بعد مرور ثلاثة عقود من عمرها، وكأن التاريخ لم يتحرك طوال تلك السنوات، إلا بالقدر الذي خسر فيه الوطن نصفه الجنوبي، وكان الثمن فقدان أرواح عزيزة من أبناء الشمال والجنوب.
تخاصم أهل الإنقاذ، أصحاب المشروع الحضاري، وديننا الحنيف يأمرنا بالتآخي والبعد عن الخصومة والفجور، فكانت المفاصلة التي عصفت بتيار الإسلاميين وقسمته إلى شطرين، ولربما بدأت معها الحرب الصامتة التي أدت إلى تآكل هذا التيار العريض فأصبح هشاً وليناً، فتعالت من الداخل الأصوات المعارضة التي امتد صداها إلى خارج الغرف المغلقة، حتى أزفت الآزفة بحلول شهر ديسمبر من العام 2018م وقد اكتملت في النفوس شرارة الثورة، لتندلع المظاهرات الشعبية بقوة، ويمتد أثرها في عدة مدن سودانية، ويبدأ الاعتصام أمام بوابة القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، ليعلن الجيش بعدها انحيازه لإرادة الشعب ويسقط نظام الإنقاذ في 11 أبريل 2019م.
كانت نهاية الإنقاذ بداية سقوط مدوي آخر للدولة في السودان، فما بين 11 أبريل 2019م و15 أبريل 2023م كان القدر يسجل أحلك فترة تمر على الأمة السودانية في التاريخ الحديث، ووجد الوطن نفسه، ما بين هذين التاريخين، فوق مرجل يغلي وتحاصره المهددات من كل جانب، حتى داهمته هذه الحرب الضروس وفتكت بشعبه وعصفت بنسيجه الاجتماعي ودمرت مقدراته، ولا يعرف أحد متى وكيف سيكون الخلاص!
يمر كل هذا التاريخ المتأزم والوطن يئن وينزف والنخب الفاشلة تواصل في ممارسة غيها المعهود، وما زلنا نردد أن “النوع السوداني” ليس له مثيل وأن علماء الجينوم البشري مخطئون إنْ أتَوا بعنصر مشابه لنا!
لقد سقطنا في مستنقع الفشل السياسي، وإلا لما كان هذا حالنا واستقلال بلادنا يناهز العقد السابع من عمره، إلا أن أسوأ فشل نتمرغ فيه أيضاً، هو الفشل الأخلاقي والمجتمعي، والذي كشر عن أنيابه بشراسة خلال هذه الحرب، فكانت العنصرية ورفض الآخر وخطاب الكراهية والخراب والدمار والقتل بدمٍ بارد وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية هي الواجهات التي يرانا من خلالها العالم، فكان ذلك قمة السقوط الأخلاقي.
نشعر بالإهانة والاحتقار ويقتلنا الغبن والقهر عندما تمارس فينا عنصرية الغرب ونتناسى ذلك الشعور عندما ننتقل من حالة الضحية إلى حالة الجاني، فيفتك بعضنا ببعض بسبب جرثومة “العنصرية السودانية” ويتفاقم داء المناطقية والجهوية فيخرج إلى العلن ذلك العفن الفكري والاجتماعي ليسمم الأجواء ويلوث النفوس.
ترى أحدهم يمشي بين الناس في خيلاء ورأسه تكاد تلامس عنان السماء لتكتشف بعدها أن رصيده في الدنيا “حفنة” نسب جهوي و”قبضة” انتماء عرقي، وما هذه الحرب إلا انعكاس فاضح لذلك المرض المجتمعي، وقد طفحت إلى السطح بوجه قبيح، جدلية المركز والهامش، في جاهلية معيبة، لم تسلم منها حتى النخب المستنيرة، وما دروا أنها مجرد فتات لا يسمن ولا يغني من جوع!
لسنا أفضل الأمم، أيها الشعب السوداني، ولكننا يمكن أن نكون كذلك، فعلاً وليس قولاً، فكيف نمنح أنفسنا كأس التفوق والتميز الأممي، ونلبس وشاح أفضل الشعوب، وما زلنا نراوح مكاننا منذ الاستقلال، وبلادنا تتأرجح من نظامٍ بائس إلى آخر أكثر بؤساً، والعالم من حولنا يتقدم، ونحن نهدم بلدنا بأنفسنا وندمر ما فيها من بنية تحتية متواضعة ويقتل بعضنا بعضاً ولا أحد يكترث بدمار الوطن وتشريد المواطن!
نحن شعب “سوداني” له ماضٍ وتاريخ وحضارة، وكذلك بقية شعوب العالم، فلندعِ التفاخر والتغني تباهياً بأهزوجة ” تخيل كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني”، فالشعوب الأخرى، ليست سودانية، ولكنها تعمل وتتقدم وتنهض، وليكنْ اعتدادنا بذاتنا وهويتنا بقدر ما نقدمه للبشرية من خدمات جليلة وأعمال خالدة تذكرها الإنسانية على امتداد التاريخ، ولنكنْ بعدها خير أمةٍ أُخرجت للناس!
وأخيراً:
(إِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ)